يعتبر موضوع "السعادة" من أجمل المواضيع التي عالجها الكتاب والمفكرون وتحدث عنها القصصيون والروائيون، وتغنى بها الشعراء، وترنم بها الأدباء، وقد تنافسوا في حسن اختيار العناوين المحببة إلى القلوب، القريبة من الأفهام، المثيرة للانتباه مثل: "مبادئ عن السعادة" و"أسباب السعادة العامة" و"رسالة عن السعادة" و"أفكار عن السعادة" و"سعادة الإنسان في هذه الحياة". كما انصرف القصصيون والروائيون إلى التحدث عن "السعادة" على لسان أبطال قصصهم ورواياتهم بعدما زين لهم الخيال مختلف صور الجمال التي من شأنها أن تجعل الحياة سعيدة في "مدينة فاضلة" يخيّل إلينا كأنها في "جزيرة السعادة" أو "مملكة الأحلام" أو "إمبراطورية الخيال".
وقد لمس الإنسان ارتياحاً في نفسه باستماعه إلى أحاديث عن السعادة، ووجد في قراءته الكتب عنها ما يلبي رغبة عنده، فازداد شغفاً بالسعادة، وحلماً بها، وتطلعاً إليها، وراح يبحث عنها في مآكله ومشاربه، وملابسه وأثاثه، وبيته وبيئته، وأهله وأصدقائه وأمواله ومجموعاته ورحلاته ومغامراته، وأعماله وسهراته ... إلخ. ولكنه كان يصاب بخيبة الأمل، ويتخيل نفسه في كل مرة كأنه أمام سراب خادع، فيتساءل ببراءة: هل ضللت الطريق؟ وتراه يسأل نفسه: وهل من سبيل للوصول إلى السعادة التي أنشدها؟ ثم لا يلبث أن ينضم إلى المتفائلين أو المتشائمين.
فالمتشائمون هم الذين يظهرون وكأنهم يحملون في أعماقهم بؤس العالم، ويشعرون بنتائج خطيئة آدم والجنس البشري كلما تحدثوا عن الأزمنة اليائسة التي شهدها النوع الإنساني فتناقلت الأجيال أخبارها وتحدث عنها المؤرخون كاشتعال البراكين، وحدوث الزلازل، وظهور الطوفان، ونزول الصواعق، واندلاع الحروب، وانتشار المجاعات، وتفشي الأمراض، واختفاء الحريات، وسيادة الظلم، وارتكاب العذاب، وفرض الاضطهاد ... إلخ. مما دفع المتشائمين إلى القول إن من الهزء أن نطلب السعادة في هذا الوجود، ومن السخرية أن نعتقد بحياة سعيدة أو غد أفضل، ومن العبث أن نؤمن بحقيقة وجود السعادة .. وأخذ المتشائمون يتساءلون: هل ولد الإنسان كي يتألم؟ وهل وجد كي تتقاذفه المصائب والنوائب، ويتلاعب به البؤس والفقر، ويلهو به الحزن والألم، ويفتك به المرض والحرب، ويقضي عليه اليأس والعذاب؟ ولماذا لا يكون السرور من نصيب النوع الإنساني؟ ولماذا لا تزين السعادة حياته ووجوده؟ .. إلخ. وقد تأثر بعض الأفراد بهذه الروح التشاؤمية التي طبعت إنتاجهم الأدبي بطابعها، وعلى سبيل المثال نذكر قول "عائشة التيمورية":
إني ألفت الحزن حتى أنني
لو غاب عني ساءني التأخيرُ
ويرى "عبدالرحمن عبدالله" دنيا من الآلام، فيقول:
وفتحت أبوابي ونافذتي
فإذا أنا بمسارح الكون
دنيا من الآلام مثلها
عمري بكل لواعج الحزن
واعتبر "أبو العلاء المعري" الحياة تعباً فقال:
تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادِ
وقد ترك شاعر الزهد "أبو العتاهية أبياتاً يائسة مثل:
لدوا للموت و ابنوا للخراب
فكلكم يصير إلى ذهاب
لمن نبني ونحن إلى تراب
نصير، كما خلقنا من تراب
وشبهت مدام "دي بويزيو" السعادة ككرة " نجري وراءها عندما تتدحرج، وندفعها بأقدامنا عندما نتوقف ... وحينما يعتزم المرء أن يستريح ويدع الكرة ويبتعد يكون جداً مرهقاً".
وقد خففت الأديان من ثقل "مأساة الإنسان الأبدية" على كاهله، وذلك بالتبشير بالإيمان في سبيل الحصول على "السعادة السماوية" الخالدة في الدار الثانية. فعلى الإنسان أن يضع نفسه دائماً في استعداد روحي، ويبرز رصيده الإيجابي في هذا الوجود. وأخذ الإنسان المكافح يدعو بأنه يجب أن لا نئن من المتاعب، ولا نضجر من المصاعب، ولا نشكو من العقبات، ولا نترك للسأم سبيلاً إلينا. فشعر الإنسان بلذة الكفاح في ميادين الحياة. وإذا كان قد تألم كثيراً فقد وجد في بعض الآلام ما جعله يشعر بعظمته وقوته وأهمية وجوده في معركة إثبات الذات. ووجد بعضهم بأن آلام الحياة إذا كانت تجرحنا فإنها تشغلنا فتنشط أفكارنا، وتشحذ قوانا، وان الوجود ليس مظلماً كما رآه المتشائمون، وهو لا يتألف من الموت المخيف والبؤس والظلم كما تصوروا، حتى إن الموت إذا وصل إلى أجسادنا، فإنه لن يصل إلى وجودنا الإبداعي والخيري والإنساني. ومهما قيل في عالمنا فإنه يبقى "أفضل العوامل الممكنة" و"أقل العوالم الممكنة سوءاً". وإن على الإنسان أن "ينسجم مع مواقع الحياة" ويتلاءم مع قانون الوجود، و"أن يعلم أنه قد قذف به في لعبة تدوم طيلة وجوده".
وأخذ المتفائلون يدعون إلى "التفاؤل بالحياة السعيدة والغد الأفضل" ويتفننون في وصف السعادة الأرضية فاعتبروا "الحقائق الهامة هي التي تسهم في جعلنا سعداء وان ما ينتهي بنا إلى السعادة هو الحق الذي لا يخدعنا و"إن الفنون الهامة هي التي تسهم في جعلنا سعداء". أما الفلسفة فإنها "يجب أن تهدف إلى تحقيق سبل سعادة النوع الإنساني، وان من أهم واجبات الإنسان هو أن يكون سعيداً ويتيح الفرص للآخرين كي يكونوا سعداء، ويسهم في تحقيق سعادة النوع الإنساني. وان الحديث عن السعادة لا يعني هروبنا من الواقع ومآسيه، وإنما يهدف إلى تحررنا من تأثيره فينا، وسيطرته علينا، وإننا إذا كنا نغمض عيوننا ونستمع إلى موسيقى جميلة فذلك كي نتمتع بلحظات سعيدة، فالسعادة قاعدة الحياة وهدفها ومبدؤها، وهي فينا وبنا ومن أجلنا، وهي حق من حقوقنا التي لا ينافسنا عليها منافس، لأن الإنسان خلق كي يكون سعيداً ويسهم في تحقيق السعادة للنوع الإنساني، وان الطبيعة تهدف إلى إسعاد الإنسان".
وللسعادة سبل عديدة تؤدي إليها وتجعل المرء يعيش في فردوسها وينعم في نعيمها، فهي في العمل الجدي الذي نحبه ويسعدنا ويتيح لنا أن نقدم إنتاجنا إلى الآخرين مقابل ما يقدمونه إلينا، وهذا العمل المفيد لا يسبب لنا أي تعب مهما طال أمده ودامت مدته، لهذا من المستحسن أن نحسن اختيار مهنتنا وفق ميولنا الشخصية ومواهبنا الفطرية، وذلك كي نعمل برغبة، ونبتكر بشغف ونبدع بنجاح مما يجعلنا نشعر بالسعادة الحقيقية إذا أن أسعد الناس أشغلهم وأنجحهم.
والسعادة هي في البذل والعطاء، والتضحية والفداء. والتعيس هو المخلوق الجبان والبخيل الذي يعيش حرمان الفقراء والمعوزين ولكنه عندما يموت يترك تركة أغنياء وإرث الموسرين. وان شمس السعادة تغرب من سماء حياتنا فور شعورنا بجفاف حياتنا ونضب عطائنا.
وقد لمس الإنسان ارتياحاً في نفسه باستماعه إلى أحاديث عن السعادة، ووجد في قراءته الكتب عنها ما يلبي رغبة عنده، فازداد شغفاً بالسعادة، وحلماً بها، وتطلعاً إليها، وراح يبحث عنها في مآكله ومشاربه، وملابسه وأثاثه، وبيته وبيئته، وأهله وأصدقائه وأمواله ومجموعاته ورحلاته ومغامراته، وأعماله وسهراته ... إلخ. ولكنه كان يصاب بخيبة الأمل، ويتخيل نفسه في كل مرة كأنه أمام سراب خادع، فيتساءل ببراءة: هل ضللت الطريق؟ وتراه يسأل نفسه: وهل من سبيل للوصول إلى السعادة التي أنشدها؟ ثم لا يلبث أن ينضم إلى المتفائلين أو المتشائمين.
فالمتشائمون هم الذين يظهرون وكأنهم يحملون في أعماقهم بؤس العالم، ويشعرون بنتائج خطيئة آدم والجنس البشري كلما تحدثوا عن الأزمنة اليائسة التي شهدها النوع الإنساني فتناقلت الأجيال أخبارها وتحدث عنها المؤرخون كاشتعال البراكين، وحدوث الزلازل، وظهور الطوفان، ونزول الصواعق، واندلاع الحروب، وانتشار المجاعات، وتفشي الأمراض، واختفاء الحريات، وسيادة الظلم، وارتكاب العذاب، وفرض الاضطهاد ... إلخ. مما دفع المتشائمين إلى القول إن من الهزء أن نطلب السعادة في هذا الوجود، ومن السخرية أن نعتقد بحياة سعيدة أو غد أفضل، ومن العبث أن نؤمن بحقيقة وجود السعادة .. وأخذ المتشائمون يتساءلون: هل ولد الإنسان كي يتألم؟ وهل وجد كي تتقاذفه المصائب والنوائب، ويتلاعب به البؤس والفقر، ويلهو به الحزن والألم، ويفتك به المرض والحرب، ويقضي عليه اليأس والعذاب؟ ولماذا لا يكون السرور من نصيب النوع الإنساني؟ ولماذا لا تزين السعادة حياته ووجوده؟ .. إلخ. وقد تأثر بعض الأفراد بهذه الروح التشاؤمية التي طبعت إنتاجهم الأدبي بطابعها، وعلى سبيل المثال نذكر قول "عائشة التيمورية":
إني ألفت الحزن حتى أنني
لو غاب عني ساءني التأخيرُ
ويرى "عبدالرحمن عبدالله" دنيا من الآلام، فيقول:
وفتحت أبوابي ونافذتي
فإذا أنا بمسارح الكون
دنيا من الآلام مثلها
عمري بكل لواعج الحزن
واعتبر "أبو العلاء المعري" الحياة تعباً فقال:
تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادِ
وقد ترك شاعر الزهد "أبو العتاهية أبياتاً يائسة مثل:
لدوا للموت و ابنوا للخراب
فكلكم يصير إلى ذهاب
لمن نبني ونحن إلى تراب
نصير، كما خلقنا من تراب
وشبهت مدام "دي بويزيو" السعادة ككرة " نجري وراءها عندما تتدحرج، وندفعها بأقدامنا عندما نتوقف ... وحينما يعتزم المرء أن يستريح ويدع الكرة ويبتعد يكون جداً مرهقاً".
وقد خففت الأديان من ثقل "مأساة الإنسان الأبدية" على كاهله، وذلك بالتبشير بالإيمان في سبيل الحصول على "السعادة السماوية" الخالدة في الدار الثانية. فعلى الإنسان أن يضع نفسه دائماً في استعداد روحي، ويبرز رصيده الإيجابي في هذا الوجود. وأخذ الإنسان المكافح يدعو بأنه يجب أن لا نئن من المتاعب، ولا نضجر من المصاعب، ولا نشكو من العقبات، ولا نترك للسأم سبيلاً إلينا. فشعر الإنسان بلذة الكفاح في ميادين الحياة. وإذا كان قد تألم كثيراً فقد وجد في بعض الآلام ما جعله يشعر بعظمته وقوته وأهمية وجوده في معركة إثبات الذات. ووجد بعضهم بأن آلام الحياة إذا كانت تجرحنا فإنها تشغلنا فتنشط أفكارنا، وتشحذ قوانا، وان الوجود ليس مظلماً كما رآه المتشائمون، وهو لا يتألف من الموت المخيف والبؤس والظلم كما تصوروا، حتى إن الموت إذا وصل إلى أجسادنا، فإنه لن يصل إلى وجودنا الإبداعي والخيري والإنساني. ومهما قيل في عالمنا فإنه يبقى "أفضل العوامل الممكنة" و"أقل العوالم الممكنة سوءاً". وإن على الإنسان أن "ينسجم مع مواقع الحياة" ويتلاءم مع قانون الوجود، و"أن يعلم أنه قد قذف به في لعبة تدوم طيلة وجوده".
وأخذ المتفائلون يدعون إلى "التفاؤل بالحياة السعيدة والغد الأفضل" ويتفننون في وصف السعادة الأرضية فاعتبروا "الحقائق الهامة هي التي تسهم في جعلنا سعداء وان ما ينتهي بنا إلى السعادة هو الحق الذي لا يخدعنا و"إن الفنون الهامة هي التي تسهم في جعلنا سعداء". أما الفلسفة فإنها "يجب أن تهدف إلى تحقيق سبل سعادة النوع الإنساني، وان من أهم واجبات الإنسان هو أن يكون سعيداً ويتيح الفرص للآخرين كي يكونوا سعداء، ويسهم في تحقيق سعادة النوع الإنساني. وان الحديث عن السعادة لا يعني هروبنا من الواقع ومآسيه، وإنما يهدف إلى تحررنا من تأثيره فينا، وسيطرته علينا، وإننا إذا كنا نغمض عيوننا ونستمع إلى موسيقى جميلة فذلك كي نتمتع بلحظات سعيدة، فالسعادة قاعدة الحياة وهدفها ومبدؤها، وهي فينا وبنا ومن أجلنا، وهي حق من حقوقنا التي لا ينافسنا عليها منافس، لأن الإنسان خلق كي يكون سعيداً ويسهم في تحقيق السعادة للنوع الإنساني، وان الطبيعة تهدف إلى إسعاد الإنسان".
وللسعادة سبل عديدة تؤدي إليها وتجعل المرء يعيش في فردوسها وينعم في نعيمها، فهي في العمل الجدي الذي نحبه ويسعدنا ويتيح لنا أن نقدم إنتاجنا إلى الآخرين مقابل ما يقدمونه إلينا، وهذا العمل المفيد لا يسبب لنا أي تعب مهما طال أمده ودامت مدته، لهذا من المستحسن أن نحسن اختيار مهنتنا وفق ميولنا الشخصية ومواهبنا الفطرية، وذلك كي نعمل برغبة، ونبتكر بشغف ونبدع بنجاح مما يجعلنا نشعر بالسعادة الحقيقية إذا أن أسعد الناس أشغلهم وأنجحهم.
والسعادة هي في البذل والعطاء، والتضحية والفداء. والتعيس هو المخلوق الجبان والبخيل الذي يعيش حرمان الفقراء والمعوزين ولكنه عندما يموت يترك تركة أغنياء وإرث الموسرين. وان شمس السعادة تغرب من سماء حياتنا فور شعورنا بجفاف حياتنا ونضب عطائنا.
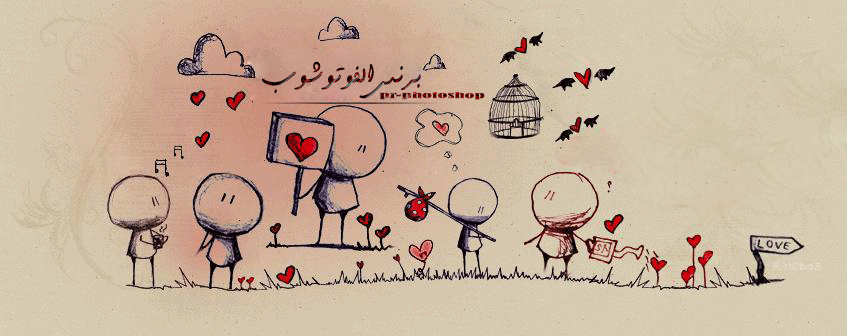

 Ahlamontada
Ahlamontada 






